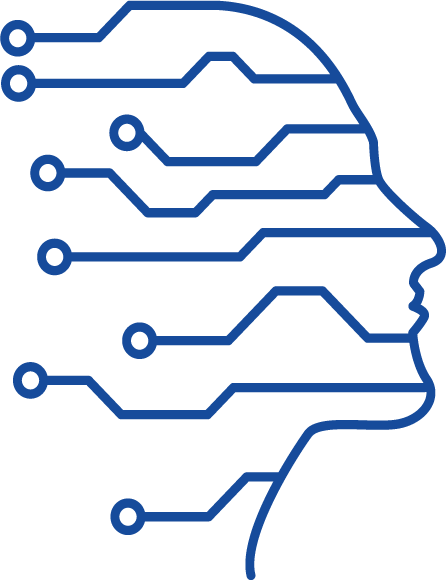أصبحت كلمة “التغير المناخي” من أكثر الكلمات رواجاً من حولنا، وأولوية من أولويات الدول، وذلك نتيجةً للخطر الكبير الذي نواجهه في عالمنا بسبب ما خلفه من آثار مدمرة على الكوكب والبشرية. بدأ رواج هذه الكلمة بتنبؤات العلماء حول تأثيرات النشاط البشري على كوكبنا وارتفاع درجة حرارته نتيجة الغازات المنبعثة من الأنشطة الصناعية، مما أدى إلى كوارث عديدة تسببت في موت الآلاف وخسائر بملايين الدولارات على كوكب الأرض.
بدأت جهود الدول لمواجهة هذا الخطر من خلال صياغة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات. ركز بعضها على تقليل الانبعاثات الغازية للدول الصناعية المتقدمة فقط، مثل اتفاق كيوتو عام 1997، بينما فرض بعضها الآخر ذلك على جميع الدول، بما في ذلك الدول النامية، مثل اتفاق باريس عام 2015.
تمثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات جهوداً جماعية من أجل تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. كما هدفت إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي لحماية المجتمعات الأكثر تأثراً وهشاشة. وشملت هذه الاتفاقيات جمع تمويلات ودعماً مالياً من الدول المتقدمة للدول النامية لتعزيز مناعتها وصمودها في وجه التغير المناخي. نصت اتفاقية باريس على جمع تمويل سنوي يبلغ 100 مليار دولار للدول النامية، وتعزيز تبادل التكنولوجيا البيئية في مجالات الطاقة المتجددة وأنظمة الإنذار المبكر والزراعة المستدامة وتحلية المياه وإدارتها.
لنعد قليلاً عبر الزمن لما قبل المعاهدات والاتفاقيات المناخية ونتذكر العالم السويدي سفانتي أرينيوس، الذي كان أول من درس وتنبأ بآثار غازات الدفيئة على الاحترار العالمي وربطها بالتغير المناخي في عام 1896. لاحظ أرينيوس أن ثاني أكسيد الكربون يؤثر على درجة حرارة الأرض، وذكر أن زيادة مستوياته تؤدي إلى ظاهرة غازات الدفيئة ومن ثم زيادة درجة الحرارة، مما يؤدي إلى الاحترار العالمي والكوارث المدمرة الناجمة عنه.
تتمثل تلك الكوارث في ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، ثم الفيضانات والجفاف وموجات الحر وتذبذب الأمطار أو انعدامها. وأكثر المناطق تأثراً هي تلك التي تفتقر إلى بنية تحتية وأنظمة إنذار مبكر وتكنولوجيا متقدمة، وهذه المناطق غالباً ما تكون في الدول النامية التي تعاني من نمو اقتصادي بطيء يعيق تعزيز مناعتها وصمودها في مواجهة هذه التغيرات. المسبب الرئيسي لكل هذه المشاكل يعود إلى حقبة الثورة الصناعية، حيث كانت الدول العظمى في طور بناء اقتصادات قوية وصناعات هائلة على حساب البيئة، من خلال انبعاثات الغازات الضارة التي تضررت منها الدول النامية بشكل أكبر.
بحثاً عن العدالة المناخية والمحاسبة، جاءت اتفاقية باريس لمتابعة ومراقبة الدول التي استنزفت موارد البيئة. وكان الهدف الرئيسي لها هو الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين، والسعي للحفاظ على ارتفاع لا يتجاوز 1.5 درجة. يتم ذلك من خلال خطط تعرف باسم “المساهمات المحددة وطنياً” (NDCs)، حيث تقدم كل دولة خطة غير ملزمة لكن تطوعية تتعهد من خلالها بتقليل الانبعاثات الكربونية.
على سبيل المثال، تعهدت المملكة الأردنية الهاشمية بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول عام 2030، في حين تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقليل انبعاثاتها بنسبة 50-52% في نفس العام. مع العلم أن هذه المساهمات غير ملزمة بأي قانون.
تركز الاتفاقية على مبدأ المسؤولية المشتركة، حيث تسعى إلى جمع تدفقات مالية تتماشى مع تخفيض الانبعاثات الكربونية وتدعيم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما أسست أسواق الكربون، التي تعمل على بيع وشراء الانبعاثات الكربونية كسلع تُباع وتُشترى. وتستثمر الدول التي تبيع حصصها الكربونية العائدات في مشاريع مستدامة مثل التحول إلى الطاقة المتجددة والمباني الخضراء. يُعد “نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (EU ETS)” أكبر وأقدم أسواق الكربون في العالم.
ومع ذلك، تواجه اتفاقية باريس تحديات كبيرة، أبرزها العوامل الاقتصادية والسياسية للدول. لذا، يجب التركيز على الاستثمار في الشباب وحلولهم المستدامة باعتبارهم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وتسريع وتيرة العمل الدولي وتكثيفه. يجب أيضاً نشر الوعي المناخي والبيئي والتوجه نحو الممارسات المستدامة مثل ترشيد استخدام الطاقة والمياه والابتعاد عن الممارسات المستنزفة لموارد البيئة.