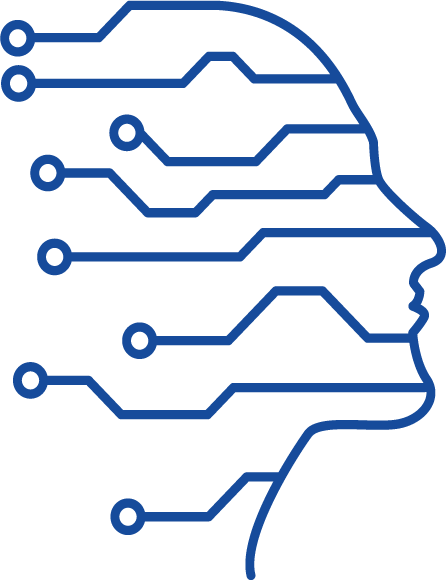تجد منطقتنا العربية بشكل عام صعوبات في استقبال أي جديد يُذكر سواء كان على شكل أفراد وجماعات بصبغة عصرية، مؤسسات ببُنى متطورة وحتى القرارت التي يتم استدخالها في السياسة العامة للدولة، وانطلاقا من أن ” الثابت الوحيد في الكون هو التغير المستمر” فإن الحضارات والتجمعات بدءَ من التي شهدت محاولات فرض سلطة وعنف بدائي حتى الدولة بأجهزتها الحالية المستقرة فجميعها على يقين بأن التغيير يطال كل فترة في عُمر أي مؤسسة وإن محاولة مجابهة هذا التغيير لغرض رفضه حفاظا على ” الوضع القائم” ما هو إلا إشعال لشرارة تغيير سيمحو هذا التصلب المؤسسي أجلا أم عاجلا.
وتبرز الحاجة لفهم فلسفة التغيير مجتمعيا ومأسستها سياسيا انطلاقا من كثرة المراحل الانتقالية التي تعيشها المنطقة بين سلطوي يميل لتعددية شكلية حتى يصل لإرهاصات عمل ديمقراطي مبتدئ وبين أنظمة تصعد قليلا وتتراجع بنفس القدر وذلك بشكل عام يتطلب فترات زمنية طويلة تحتاج لقدرات استيعابية تُجيد الاستفادة من التجارب الفاشلة مؤسسيا على قدر الناجحة برفعها مرحليا وذلك ما قد يظهر بشكل جلي في ” ذاكرة النظام” التي تساعده في استرجاع وتحليل أكبر قدر من التحركات الممكنة لتمكنه من خوض مناورات أكثر جرأة واتزان في آن واحد مع الخبرة المتزايدة والمتراكمة.
تتميز النقلات النوعية التي يحملها عالم الاتصال والتكنولوجيا بمرونة وصولها وإتاحتها بالحد الأدنى لدى أغلب الفئات على مستويات الدولة والتجمعات كافة وتراكم وصولويتها مع عوائدها اللافتة في التجمع البشري وذلك ما يعطي مؤشرا على الأثر المحتوم جراء هذه الحركات السريعة تقنيا وماديا ما يفسح المجال لفضائات اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة لتكون جزء من عملية رسم القرار أو تسيير الأوضاع العامة كل حسب مناطق نفوذه، وهذه الفئات الجديدة التي “تنتهز” الفرصة اقتصاديا ما يعني تفرعها اجتماعية حتى تصل للخيط الأخير من الشبكة سياسيا يضمن بقائها في اللعبة السياسية بشكلها الحالي ولعل هذه اللوحة لا تكتمل إلا بارتطام طبيعي وصحي مع الفئات التي لها مقعد محجوز مسبقا مع تلك الجديدة وهذا يطرح سؤال عفوي حول ما الآلية المتبعة للتعامل مع كليهما ؟ هل سيحدث تنازل أم مساومة ؟ مين سيولي النظام أهمية أكثر من غيره؟ هل العوائد من الفئات الجديدة مضمونة أم هناك هامش خسارة سياسي ومجتمعي؟
كما بدأنا حديثا حول التغيير فإن المعادلة عند الحديث عن الأنظمة تتطلب توافر عنصر التكيف وعنصر الخبرة ضمن دائرة التدرج فإن النظام إن لم يحظ باللحظات التاريخية اللازمة لاستحضار المواقف المماثلة فإن عامل التكيف ضروري لا محالة باستعياب الفئات الأقدر على حمل المرحلة الجديدة التي حققوا شروط دخولها ما سيساعد النظام بتسريع عملية تمهيد ” الصور” الجديدة لنفسه، واللآن سنقوم بتسليط الضوء على الحالتين القديمة والجديدة في الانتقال المؤسسي:
– إن تناولنا الفئات القديمة سواء كانت بُنى قِبلية أم عشائرية، أفراد وتجمعات ذات نفوذ اقتصادي، بُنى ذات إرث سياسي من نظام سابق ولها ثقل اجتماعي فإن من المُستهجن استبعاد هذه العناصر عند أخذ خطوات جادة نحو أي انتقال ديمقراطي للدولة، وذلك انطلاقا من عدة أسباب أهمها الحفاظ على حالة الاستقرار المعهود ما قبل التحول لنظام بحلة جديدة لأن هذا التحول يحمل بلا محالة حالة فوضى حتمية لا يمكن الفرار منها إلا بمأسسة الفوضى وتنظيمها باقتصارها على تهديدات يمكن حصرها وبضمان عدم مس حالة الفوضى بأي خطوات تغيير حيوية قد تعمل على تخريب الانتقال برمّته، فهذه الفئات القديمة في حالة التأكيد على محورية أدوارها ضمن دائرة ضمانات متجددة تحميها من الإهمال خلال وبعد التغيير فإن دورها هنا سيرتبط بوجودها فعدم وجودها يعني انتهاء أي شكل دور مستقبلي لها قد تلتهمه الفئات الجديدة بعد ترسيخ دعائم النظام في مراحله الجديدة.
– عند تقديم الضمانات المرحلية المرتبطة بأدوار واضحة للفئات القديمة فإن الفئات الجديدة سواء أكانت أحزاب أم هئات، جماعات وغيرها من التي يستدخلها النظام وترغب بأن تكون شريكة في اللعبة السياسية ستقوم بخلق أدوار جديدة واحتواء فراغات موجودة في البنى المؤسسية والتنظيمية وذلك بالتأكيد يصب بمصلحة النظام من اعتبار أن المساحات التي قد تشكل ناقوس سؤال قبل أن تتحول لخطر سيتم احتوائها ووضعها في حيز العمل لا الإهمال المؤسسي ما ينعكس على النظام على شكل عبور سياسي منظم وإن لم يكن سهل كونه صعوبة وهشاشة المرحلة الانتقالية قائمة أصلا، فيضمن النظام وجود عناصر على اطلاع على البيئة الموجودة ويحمل تصور للبيئة المقبل عليها ويُنشأ خطاب وخط جديد يكون وجوده ضروري في خضم التغييرات الكبيرة التي يترقبها النظام ما يُسهل عليه فهم حالة التعقيد ومأسستها مستقبلا.
لعل دور النظام ما بين الفئات جميعها يكمن بقدرته على احتواء القديم واستيعاب الجديد وذلك انطلاقا من قابليته على التكيف مع أي حالة اصطدام في المرحلة ما قبل الانتقال وذلك لا يعني سهولة قدرة أي نظام على تقديم ردود تناسب المرحلة بتعقيداتها لكن في حالة الأنظمة العربية قيد التطور فإن أي جهود تُبذل لفهم التوزيع المجتمعي المعقد أصلا قد تحمل بالأفق نتائج إيجابية لقدرات النظام المستقبلية على خلق بيئات سياسية واجتماعية واقعية خالية من الطموحات الرومانسية ومليئة بالحلول المتدرجة والمعقولة، وقد نتسائل سويا، ماذا لو قام النظام بدمج الفئات القديمة والجديدة بروابط مصالحية وسياسية بطابع مؤسسي منطلقة من فكرة الأدوار والبقاء للأكثر تكيفا والقدرة على العطاء مرحليا بشكل أنضج؟ وهل سيشجع هذا على ذوبان الفئات التي لا تجد لها أدوار وظيفية جديدة؟